الإسلام في إفريقية
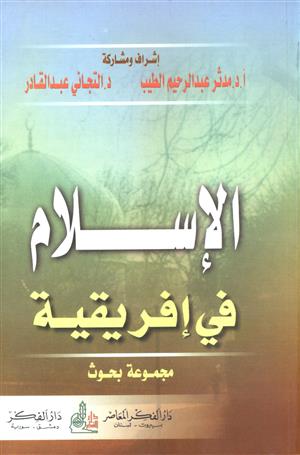
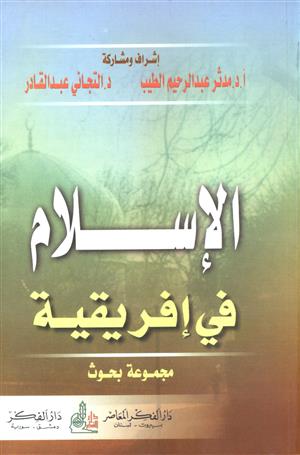
الإسلام في القارة الإفريقية:
آفاق المستقبل
أ.د. مدثر عبد الرحيم الطيب
1- مقدمة:
1 - من نوافل القول أننا إذ نطرق أبواب الحديث عن مستقبل الإسلام في القارة الإفريقية لا نقصد لشيء من التكهن أو الرجم بالغيب - فالغيب لا يعلمه إلا الله؛ كما أننا لا ننطلق من هواجس القلق، ولا ننساق وراء الأحلام والتمنيات - فليس التعلل بالأوهام أو التجمجم أمام التحديات مما نركن إليه إذ نسعى جاهدين لاستشراف معالم المستقبل استشرافاً لا يكون إلا باستقراء وقائع التاريخ، ما سر منها وما لم يسر، وإلا بسبر حقائق الحياة، ما جل منها وماصغر.
2 - أ. وعل أبرز وقائع تاريخ القارة الحديث وواقعها الماثل اليوم أنها قد ظلت طوال القرن المنصرم موضع تنازع وتشاحن بين الدول والشركات المتصارعة بغية السيطرة على خيرات القارة ومعطياتها ولا سيما المعادن والنفط والمنتجات الزراعية. ومع التسليم بتداخل الحقب في تاريخ إفريقية كما في تاريخ غيرها من القارات والبلدان، فربما أمكن إجمال الحديث في هذا الصدد كقولنا: إن إفريقية قد تعرضت في أثناء القرن المنصرم، لثلاث هجمات عسكرية وسياسية متتالية:
الهجمة الأولى: بدأت بمؤتمر برلين 1885م وما تمخض عنه من تقسيم الأجزاء التي لم يسبق الاستيلاء عليها من القارة بين الدول الأوربية المستعمرة، ثم استعمرت، واستمرت آثارها على القارة وأهلها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية .
أما الهجمة الثانية فقد بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وامتدت حتى انهيار النظم الشيوعية في الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية أواخر عقد الثمانينيات، وقد تميزت تلكم الفترة باشتداد التنازع والتنافس بين الكتلتين الرئيسيتين: الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي وتوابعه المنضوية في حلف وارسو، والغربية بقيادة الولايات المتحدة وحليفاتها على شاطئ الأطلنطي - مع بروز دور متميز للصين عقب تبلور الخلاف والنزاع بين الصين الشيوعية من جهة، والاتحاد السوفيتي من جهة أخرى أوائل الستينيات .
وبانهيار الشيوعية العالمية بدأت مرحلة جديدة يشهد فيها العالم وتشهد فيها القارة الإفريقية (ولا سيما الأقطار التي تبلورت فيها حركات إسلامية تجديدية فاعلة: كما هو الحال في مصر والسودان وتونس والجزائر).
هجمة ثالثة: تقودها الولايات المتحدة في إطار مايعرف بالنظام العالمي الجديد الذي تجري صياغته أساساً على يديها متضمناً إعادة النظر في عدد من ثوابت القانون الدولي (على رأسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية) ومستهدفاً فرض نظم تتسم بالعلمانية في توجهاتها الفلسفية، وتلتزم النهج الرأسمالي في تنظيم الحياة الاقتصادية، وبالليبرالية في تنظيم الدول والعلاقات الاجتماعية على الأقطار والشعوب المعنية .
2-ب. هذا وقد صاحبت تلكم الهجمات العسكرية السياسية الثلاث وتداخلت معها في مختلف مراحلها - بل سبقتها جميعاً ومهدت لها في كثير من الأحيان -.
هجمة رابعة لم تكن أقل عتواً ولا أخف وطأة على القارة وأهلها: تلك هي هجمة الكنائس الغربية: كاثوليكية، ولوثرية وانجليكيانية. إلخ.
وعلّ من أطرف ما اتسمت به تلك الهجمة الدينية أن الكنائس الغربية الغازية لم توجه جهودها التنصيرية ضد الديانات القبلية التقليدية، أو ضد الإسلام الذي كان قد تجذر في القارة وتوطن بين أهلها عبر القرون وحسب، بل وجهت جهودها التنصيرية أيضاً ضد الكنائس المسيحية الإفريقية العريقة التي كانت قد استقرت وازدهرت في بلاد كمصر وإثيوبية، حتى قبل أن تدخل المسيحية إلى أوروبا وتنتشر بين أهلها. فكان سلوك المبشرين الأوروبيين والأمريكيين تجاه القبط والكنيسة القبطية في إفريقية مماثلاً لسلكوهم تجاه المسيحيين الشرقيين (كالسناطرة واليعاقبة، والأرثوذكس) وكنائسهم العريقة في آسيا: سلوكاً استعمارياً مستعلياً، ينطوي على فرض التبعية والتغريب، ويجر في ثناياه الصهر والتذويب الحضاري.
3- وثمة نقطة تمهيدية أخيرة لابد من الإشارة إليها في هذا المقام: هي شح الإحصاءات الدقيقة التي يمكن الاعتماد عليها، وتضارب التفسيرات والتحليلات للموجود المتاح من أرقام ومعلومات - حتى الصادرة منها عن المراكز والجهات نفسها. ومن أمثلة ذلك عدد من الدراسات الغربية والكنسية يؤكد انتشار الإسلام بين الأفارقة بالمقارنة مع المسيحية بسرعة فائقة قدرت بنسب تتراوح بين اثنين إلى واحد، وعشرة إلى واحد.
وذلك بينما أعلن بابا الفاتيكان ((وقد ظل يعير القارة اهتماماً كبيراً عبرت عنه زياراته المتكررة لها في أثناء زيارته الأخيرة قبل بضع سنوات أنه يتوقع أن يطوى بساط الإسلام عن القارة الإفريقية قبل آخر هذا القرن العشرين، وأن تخفق بدلاً عنه رايات المسيحية في مختلف أرجائها)).
ولكن النظرة الموضوعية القائمة على استقراء وقائع التاريخ وحقائق الحاضر استقراءً سليماً مجرداً عن الأهواء والأفكار المسبقة، تبين لنا أن الإسلام يواجه تحديات كبيرة لاشك في عظمها وخطرها، غير أنه برغم ذلك يتمتع بمزايا ذاتية وموضوعية لا تضمن بقاءه وثباته داخل القارة وحسب، بل ترجح استمرار انتشاره واتساع دائرة الداخلين فيه أفراداً وأفواجاً من الأفارقة وغيرهم خارج إفريقية وعبر حدودها في مختلف أنحاء العالم كذلك..
2- التحديات التي تواجه الإسلام والمسلمين في القارة:
يمكن استعراض أهم التحديات التي واجهت الإسلام والمسلمين في القارة الإفريقية في أثناء القرن المنصرم، وما زالت تواجههم اليوم، ضمن أربعة محاور رئيسية هي عوامل الضعف الداخلية التي فتت عضد المجتمعات الإسلامية في القارة، وجعلتها نهب الغزاة والطامعين. ثم تجربة الاستعمار بما انطوت عليه من اغتصاب وانتهاب، وبما تمخضت عنه - حتى بعد نيل الدول الإفريقية استقلالها السياسي - من عوامل الاغتراب والاستلاب، ثم دور كل من الصهيونية والتنصير في تكريس عوامل الضعف، وتعميق التبعية والاستلاب.
4-أ: أما عوامل الضعف الداخلية، فلعل أبرزها وأوضحها حالة التردي الحضاري والتخلف الاقتصادي والاجتماعي التي سرت في المجتمعات الإسلامية عامة، والإفريقية من بينها منذ انهيار دولة الموحدين (التي شهدت عصر الازدهار الحضاري بين المسلمين) حتى خيمت عليها جميعاً وصار آخر الأمر من سماتها الثابتة اللازمة: فاتسعت بذلك الشقة بين المثل السامية التي صاغها الإسلام ودعا المسلمين لصياغة أوضاعهم على شاكلتها في كل باب من أبواب الحياة، وبين الواقع الحزين الذي آلت إليه أحوال المسلمين - تلك الحال التي أحسن الأستاذ مالك بن نبي عليه رحمة الله إذ أوجز وصفها فسماها حالة (القابلية للاستعمار).
ولعل من أوضح مظاهر ذلك التردي تفشي التقليد والتعصب المذهبي، بل التعصب لهذا الشارح أو ذاك من شراح المذهب نفسه، بين المسلمين المتأخرين في إفريقية كما في غيرها من أنحاء العالم الإسلامي حتى اتخذ بعضهم شعاراً مؤداه: ((نحن خليليون، إن أخطأ خليل أخطأنا، وإن أصاب أصبنا)). وحتى رأينا المسلمين في يوغندا مثلاً ينقسمون انقساماً بعيد الغور بين الجمعية - الذين يرون أن صلاة الجمعة تجزئ عن صلاة الظهر - و (الظهرية) - الذين يرون أن لابد لمن صلى الجمعة من أداء صلاة الظهر بعدها. - بينما رأيناهم في نيجيريا يتقاتلون حتى قتل بعضهم بعضاً داخل المسجد، كما حدث في كدونا من كبريات مدن الشمال المسلم، وذلك بسبب التنازع بين المنحازين للطرق الصوفية من جهة، وبين ناقديهم ومنافسيهم من الوهابية أو أنصار السنة المحمدية من جهة أخرى.
هذا بينما تضاءلت العلوم، وضاقت آفاق القائمين بأمرها بعد الازدهار الذي شهدته أيام مجد (القرويين وتنبكتو). فانحسرت الهمم عما كانت قد تعلقت به إذ ذاك من تطلع لاستكشاف أسرار الكون في كل ميدان من ميادين العلوم الكونية والتطبيقية، بما في ذلك الفلك والطب والكيمياء إلخ.. وانحصرت في دوائر من العلوم الدينية ما زالت تضيق وتزداد ضيقاً مع مرور الزمن حتى صارت إلى ما نعاه الإمام الخميني على من أسماهم (فقهاء الحيض والنفاس) من انصراف عن البحث في المهمات من فقه المعاملات وقضايا الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وانغلاقهم في أضيق دوائر فقه العبادات والأحوال الشخصية .
وازداد الحال سوءاً بامتداد التردي إلى مناهج الدرس وطرق التعلم والتعليم حتى أصبحت تدور في دوائر مفرغة من شرح النصوص، واختصار الشروح، ثم التعليق على المختصرات، والعودة لبسط القول فيها، والتحشية عليها، وهكذا دواليك؛ مما حدث في مختلف أنحاء العالم الإسلامي إبان عهود التخلف والانحطاط التي ضاعف ظلمة ليلها تفشي الجدل وانتشار الخرافات حتى بين من أخذوا بنصيب من العلوم المتاحة في تلك الظروف والأيام.
وغني عن القول أن حالة التخلف العلمي والفكري السائدة إذ ذاك، إضافة لما واكبها من تعصب وخلافات قد قعدت بالمسلمين الأفارقة كما قعدت بنظرائهم في غير إفريقية من دار الإسلام: ليس فقط عن مواكبة التقدم الذي ارتقى بالشعوب التي كانت فيما مضى تعدُّ في عداد الهمج المتوحشين، بل قعدت بهم حتى عن حماية البيضة ومدافعة الأعداء الذين ما لبثوا أن تغلبوا عليهم وتملكوا ديارهم فزادوهم بذلك خبالاً على خبال، وخسراناً بعد خسران.
4 - ب. وكما هو معلوم فإن سياسات أولئك الغزاة المتنصرين لم تكن تستهدف بسط النفوذ أو السيادة الأوروبية على الشعوب المقهورة وحسب، كما أنها لم تنحصر في استنزاف خيرات البلاد واحتكار أسواقها فقط، بل كانت تهدف مع هذا وبجانبه، إلى السيطرة الروحية والحضارية على الشعوب المستعمرة والمقهورة، وقد عبر فاسكو داجاما عن ذلك بقولته المشهورة إذ حط الرحال في كليكوت عام 1498م: ((لقد جئنا باحثين عن البهارات والتوابل، ساعين لنشر المسيحية بين الناس)).
وهكذا ارتبط التبشير الديني، ثم بعد ذلك التبشير بمختلف المذاهب والدعوات الأوربية: فكرية، وفنية، وسياسية بالتوسع الاستعماري منذ بدايته وأول أمره.
وكما قد نتوقع والحالة هذه، فقد أعيدت صياغة نظم الحياة الاقتصادية والسياسية والتربوية والتشريعية والاجتماعية في المستعمرات الإفريقية وغير الإفريقية بحيث أصبحت تقوم في كل ذلك إما على الأنماط الأوروبية المختلفة (فرنسية أو إنجليزية، أو برتغالية إلخ... حسب أنواع الدولة الحاكمة) وإما على أساس من الثنائية أو الازدواجية حيثما وجدت مجتمعات إسلامية يؤبه لها؛ بحيث يكون ثمة نظامان اثنان في كل ميدان من ميادين الحياة المعنية: أحدهما أوروبي حديث مقتدر ومسيطر على المواقع الاستراتيجية في حياة المجتمع، والآخر إسلامي في توجهه العام، ولكنه عتيق في بنائه وشكله، ضعيف في أدائه وحركته، محصورة آثاره كذلك في أركان المجتمع القصية المتخلفة.
ولما كان المغلوب أبداً مولعاً بمحاكاة غالبيةكما لاحظ ابن خلدون، فقد استهوت أنماط الحياة الأوربية ونظمها المختلفة قلوب قطاعات كبيرة من الناس في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، إفريقية وغير إفريقية. فساروا طائعين، بل متحمسين، في ركاب التغريب والمستعمرين - ولم يكن ذلك فقط أيام تبعيتهم السياسية المباشرة لسلطان سادتهم الأوروبيين، بل حتى بعد أن نالت بلادهم استقلالها السياسي وأصبحوا بذلك - على الأقل رسمياً وشكلياً - في عداد الأحرار المستقلين.
هذا ومن دواعي العجب والدلالات المعبرة عن مدى انسلاخ أولئك المستلبين عن حضارتهم وقيمهم الإسلامية وحرصهم على الارتباط بحضارة سادتهم الأوروبيين، أن كثيراً ممن استبشعوا استمرار ارتباطهم بالمستعمرين الغربيين قد راحوا يلتمسون العزة والخلاص في تبعية جديدة ألحقتهم بالأوروبيين الشرقيين وفلسفتهم الشيوعية التي كانت أكثر ازدراء للإسلام ونكاية بالمسلمين من ليبرالية نظرائهم الغربيين.
وهكذا رأينا أصنافاً شتى من هؤلاء وأولئك يتبارون في تشويه الإسلام والعسف بالمسلمين في إفريقية وفي غيرها - تحت لواء الشيوعية أو العلمانية تارة، وباسم الاشتراكية أو القومية تارة أخرى، وباسم الديمقراطية وحقوق الإنسان مرات عديدة أخر - وحتى عندما يفوز الإسلام والمسلمون بأغلبية ساحقة من أصوات الناخبين في انتخابات حرة يشرف عليها أولئك المستبدون المطففون الذين كثيراً ما يتجاوزون في عسفهم بمواطنيهم المسلمين، حدود مالم يجرؤ عليه حتى سادتهم الذين يتقربون إليهم بمصادرة الحريات، وإراقة الدماء، والكذب على الله والناس أجمعين!!
وإذا كان هذا هو الحال في تلكم الأقطار التي يكاد جميع سكانها يكونون من المسلمين فلا غرو أن يكون الحال أشد تعاسة وكرباً حيث يكون المسلمون أقليات ضعيفة، أو أغلبيات مستضعفة لتخلفها الاقتصادي والاجتماعي، أو لعجزها السياسي والعسكري، أو لغير هذه وتلك من أسباب.
4- جـ. وإذا أدى ذلك القدر من الاستلاب الحضاري الذي شمل دوائر العمل والفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى كل ما تقدم من خراب وويلات، فلا شك أن الاستلاب الديني - بما يتضمنه من تبدل عميق في نظرة الإنسان لنفسه وللكون والخالق - أبعد أثراً في زلزلة المجتمعات وإذلال الدول والحكومات.
ولذلك رأينا كثيراً من قادة الفكر والعمل العام في الدول الإفريقية الذين كانوا قد تنصروا بعد أن كانوا من أهل الديانات القبلية يسعون جهدهم للانعتاق مما كان قد فرض عليهم وهم قصر أو أيام الهيمنة الاستعمارية المباشرة على بلادهم من أغلال التبعية الدينية، ومن أجل استرجاع هويتهم ودياناتهم الإفريقية الأصلية، فالسيد أليكسي كويسون ساكي سفير غانا وممثلها في الأمم المتحدة على عهد الرئيس الراحل كوامي نكروما يقول محتجاً في ترجمته الذاتية: (لقد كان من آثار المبشرين - على اختلاف فرقهم - محو جميع معالم الثقافة الإفريقية أو قمعها في نفوس المبشرين... حتى أسماؤنا ألغيت ومحيت واستبدلوها عمداً بأسماء إنجليزية .. وعندئذ كان الواحد منا يشعر بأن شخصيته كانت تتآكل تدريجياً، أو أنها، على أقل تقدير، تطلى بطلاء غير إفريقي يغطيها تماماً ويغير سمتها) ويخطو الشاعر التوجي الدكتور أرماتو، خطوة يتجاوز فيها الاحتجاج والاستنكار إلى مرحلة يعيد فيها صياغة المسيحية الأوروبية الوافدة بمسيحية زنجية يبتهل العاكفون في كنائسها إلى مسيح أسود، بل إلى إله أسود كذلك، ترفرف حوله ملائكة سوداء فيقول: ((مصوراً إلهه في صورة بشريةكما يفعل المسيحيون عادة:
إن إلهنا أسود
أسود خالد السود
له شفاه غليظة شهوانية
شعره جعد ملبد
وعيونه سوداء براقة السواد
على صورته خلقنا
إلهنا هذا الأسود الجميل))
هذا بينما ينقل قادة نقابات العمال في الكميرون والقادة الوطنيون والسياسيون في زائير المعركة من عالم الفكر والشعر إلى معترك السياسة والصراع من أجل المعاش ويمضي بعضهم فيخلع المسيحية عن عنقه طالباً الحياة والنجاة في ظل غيرها من الديانات الوطنية، تقليدية أو سماوية.
وإذا كان ذلك حال كثير من الأفارقة الذين تنصروا ممن لم يكونوا أصلاً من المسلمين، فلا غرابة أن رفضت الأغلبية العظمى من الأفارقة المسلمين الانجرار في ركاب المنصرين ابتداءً ومن أول الأمر، مما دفع واحداً من أكبر واضعي استراتيجيات العمل المسيحي في إفريقية للتشكي مما أسماه معاندة الإسلام والمسلمين في وجه المسيحية والمنصرين، ولكن ذلك لم يثنه وزملاءه عن المضي في إحكام الخطط وبذل الجهود والأموال للتغلغل بين المسلمين ومحاولة تنصير من قد يضعف منهم أمام إغراءات الرفد والإعطاء وهم جائعون فقراء، أو الدواء إذ تفتك بهم الأمراض والأدواء، أو التعليم الحديث والجهل متفش بينهم فأفئدتهم هواء.
وكما هو معلوم مشهور، فقد استجابت أعداد معتبرة من المسلمين -أفراداً وأسراً وجماعات- لتلك الإغراءات، ولاسيما في ظروف اشتدت فيها ضغوط الفتنة والابتلاء باشتداد الجفاف والتصحر والمجاعات والحروب الأهلية في بلاد القرن الإفريقي، وعبر الحزام الصحراوي الممتد من غرب السودان إلى النيجر وتشاد وما جاورها من الأقاليم والبلاد.
4-د. هذا وإن الحديث عن التحديات التي تواجه الإسلام والمسلمين في إفريقية - مهما كان مختصراً- لا يمكن أن يكتمل دون الإشارة لإسرائيل ودورها في القارة، ولعل أهم المحاور التي ظلت سياسة إسرائيل تدور حولها في إفريقية هي: عزل الدول والمجتمعات العربية عن رصيفاتها غير العربية في القارة، مع توثيق علاقات الصداقة والتعاون بينها وبين الأخيرة ضد الأفارقة العرب ولاسيما في حوض النيل وشمال القارة؛ ثم بسط نفوذها وسيطرتها على المواقع الإستراتيجية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي تحقيقاً للأهداف نفسها سالفة الذكر وبالطرق والأساليب نفسها؛ ثم دعم تحالفها الاستراتيجي مع جنوب إفريقية - ذلك الحلف القائم على تشابه النظامين وتطابق المصالح المشتركة بينهما: قهراً للوطنيين والسكان الأصليين بناء على فلسفة عنصرية استعلائية بزعم كل من النظامين بموجبها أن له حقاً في الأرض المتنازع عليها يسمو فوق منطق العقل وسائر القوانين، وتحالفاً لتلك الأسباب مجتمعة مع قوى الاستعمار العالمي.
وإذ لايلزمنا استقصاء القول في تطور النزاع العربي الإسرائيلي عامة، أو في تطور علاقة كل من إسرائيل والدول العربية بالشعوب والأقطار الإفريقية في هذا المقام، فسنكتفي بالإشارة إلى أن إسرائيل قد ظلت قادرة على التعامل مع حكومات الدول الإفريقية غير العربية وشعوبها - بما في ذلك دول يكون المسلمون أغلبية سكانها مثل السنغال وتنزانيا ونيجيريا - كما لو لم يكن للإسلام وجود، وذلك برغم عظم الرصيد الهائل من التعاطف الذي نتج عن انتشار الإسلام وحضارته بين الأفارقة تجاه كافة المسلمين - بما في ذلك العرب بوصفهم الدعاة الأولين - ولا سيما منذ سقوط القدس واحتلال المزيد من أرض فلسطين عام 1967م.
وعَلَّ تفسير ذلك الشلل الذريع مما يلتمس في أمرين مختلفين مضموناً وشكلاً، ولكنهما متكاملان متفقان نتيجة وأثراً.
أولهما: أن تحركات معظم الدول العربية التي حرصت على الانطلاق في تعاملها مع القارة من ذلك الرصيد الديني الحضاري برغم ما وفقت إليه من نجاحات جزئية مبعثرة قد فشلت في جملتها بسبب ما اتسمت به معظم الأحيان من تخلف وقصور في التصور والتنفيذ. ولأنها قد اتجهت لذلك وفي كثير من مساعيها وجهة مذهبية منغلقة أقلقت حتى المسلمين من أهل القارة. كما ارتبطت - ولا سيما فيما يتعلق بمعاملة غير المسلمين من الإفريقيين - بفهم ضيق للإسلام جرد به عن شموليته وإنسانيته، وفصل فيه بين أهداف تلك الدول السياسية ومقاصد الإسلام الأصولية الهادفة لتحرير الإنسان أيا كان، والذود عن كرامته وبذل غاية الجهد لتخليصه من صنوف الظلم والقهر والعدوان.
وثانيهما: أن أكثر الدول العربية قدرة على استقطاب الإمكانات المتاحة في ذلك المجال - وعلى رأسها مصر التي قطعت شوطاً كبيراً في التحرر من عقابيل الرجعية السياسية والاجتماعية منذ ثورة 1952م، ثم الجزائر التي أثارت بجهادها الرائع في أثناء حرب الاستقلال إعجاب العالمين - قد أقامت سياساتها الداخلية والخارجية على أسس علمانية أسقطت بها الإسلام من حساباتها (إلا فيما يتعلق بالأمور الشعائرية أو الشكلية والأغراض العملية البراجماتية)، وفي وقت كان فيه عدد من زعماء الدول الإسلامية الإفريقية (من أمثال هاماني ديوري في النيجر، وداودا جواري في غامبيا) بعيدين بدورهم بعد نظرائهم العرب عن التعامل الإيجابي الفعال مع الإسلام ومتطلباته السياسية، فمضوا - لذلك - يعقدون المعاهدات مع إسرائيل، ويطورون مختلف أنواع العلاقات معها دون أن يروا في ذلك بأساً ولا حرجاً، بل تصرفاً طبيعياً منطقياً اتخذوه تحقيقاً لما استهدفوه في منظورهم العلماني من مصالح بلادهم الوطنية.
وقد زاد الطين بلة توقيع اتفاقيات كامب ديفيد وما اتصل بها من إجراءات الصلح المنفرد الذي فاجأت به مصر السادات العالم أجمع. فبينما أحدثت تلك التطورات كثيراً من البهجة والارتياح عند تلك المجموعة من الدول الإفريقية التي ظلت تتعامل مع إسرائيل برغم قطع علاقاتها الدبلوماسية معها عام 1973م ، فلا شك أنها قد ولدت شعوراً مريراً بالإحباط والخذلان عند مختلف الدول والأفراد والجماعات ((ولا سيما بين الأفارقة المسلمين وغيرهم ممن ربطتهم بالعرب وقضاياهم روابط التضامن السياسي والالتزام الإيديولوجي)) الذين كانوا قد وقفوا مع مصر والعرب، وأيدوهم عبر السنين في كفاحهم الطويل ضد إسرائيل وسياساتها العدوانية في الجبهتين العربية والإفريقية.
ولم يكن مستغرباً أن حذت كثير من الدول الإفريقية حذو مصر في تطبيع علاقاتها وتوثيقها مع إسرائيل - بما في ذلك دول شديدة الإحساس بعمق التزامها الإسلامي وارتباطها بالعالم العربي مثل نيجيريا.
خلاصة القول: إن التحديات التي تواجه الإسلام والمسلمين في إفريقية - سواء أكانت داخلية تعود لوهن المجتمعات الإسلامية الإفريقية وأدواتها الذاتية، أم خارجية ترتبت على الهجمات والسياسات الاستعمارية وعقابيلها، أو نتجت عن الحملات التنصيرية والسياسات الإسرائيلية والصهيونية فيها - هي تحديات كبيرة خطيرة لا يمكن التقليل من شأنها، بل يجب مواجهتها والتماس الحلول الناجعة لها.
ولكن جميع تلك التحديات - وإن عرقلت مسيرة الإسلام والمسلمين في القارة، وألحقت بهم أضراراً لا شك في خطورتها - لا تشكل في تقديرنا مانعاً يمنع الإسلام والمسلمين في هذه القارة من الانطلاق، بثقة وعزم، نحو المستقبل، والقيام بدور هام في صياغة ذلك المستقبل لا على الصعيد الإقليمي وحسب، بل على الصعيد العالمي كذلك.
يمثل هذا الكتاب مجموعة من أبحاث المتخصصين في تاريخ القارة الإفريقية حول موضوع بالغ الأهمية لهذه المرحلة الراهنة من مراحل الإسلام في إفريقية وخصوصاً بعدما انهارت الشيوعية العالمية واشتدت الهجمة الجديدة على العالم الثالث أجمع، في إطار ما يُعرف بالنظام العالمي الجديد.
وتأتي أهمية موضوع الإسلام في إفريقية لدى المسلمين وغيرهم من أهل القارة الأم ومن المنحدرين من أصول إفريقية من كونه يمثل قطب الرحى في قضية الانتماء والهوية المحورية، كما يرتبط أوثق ارتباط بعدد من كبريات القضايا المصيرية الأخرى، وعلى رأسها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأساليب التعامل والسلوك بين مختلف الجماعات والسلالات البشرية.
أشرف على الكتاب أستاذان كبيران متخصصان في الموضوع، يعيشان الأزمات المطروحة.
الإسلام في إفريقية - مجموعة بحوث - إشراف ومشاركة أ.د. مدثر عبد الرحيم الطيب -د. التجاني عبد القادر
يتناول هذا الكتاب مجموعة مختارة من أبحاث نخبة طيبة من المتخصصين المهتمين بدراسة أحوال إفريقية ماضياً وحاضراً، ونبذة عنهم، في موضوع (الإسلام في إفريقية) والمؤتمر العالمي الأول المنعقد حوله عام 1992، وبرنامجه وبيانه الختامي.
ويمثل الموضوع قطب الرحى في قضية الانتماء والهوية المحورية، ويرتبط بكبريات القضايا المصيرية الأخرى، وخصوصاً بعد انهيار الشيوعية العالمية، واشتداد الهجمة على العالم الثالث أجمع في إطار نظام العولمة الجديد.
ويقدم الكتاب مشروع رؤية إسلامية ونظرات منهجية في الأديان التقليدية في إفريقية، وفي منهجية دراسة الإسلام فيها، ودراسات قطرية وإقليمية في التفسير والسياسة في الشمال الإفريقي، والإسلام السياسي في الجزائر، وموقف الخلافة السكتية من الاستعمار البريطاني، وموقف الأمراء والعلماء في المهدية من تجربة الحسين الزهرا.
ويؤرخ لنشأة الحركة الإسلامية الحديثة في السودان، والحروب الصليبية والبحر الأحمر، وللإسلام وبدايات المقاومة الوطنية عند الصوماليين، والحركات الثورية في إثيوبية، ومستقبل القرن الإفريقي، وحركة الإسلام في زمبابوي.
ويوضح خطة مؤتمر كلورادو بأمريكة الشمالية لتنصير مسلمي إفريقية.
ويبين آفاق الإسلام في إفريقية، والخواطر حول مستقبله فيها.
ويختتم الكتاب بأبحاث في الإنكليزية حول العلامات الطبيعية في الهندسة الإسلامية في شرقي السودان، وحركة الشباب المسلم في جنوبي إفريقية، والحركة الإسلامية في الأقلية المسلمة.
