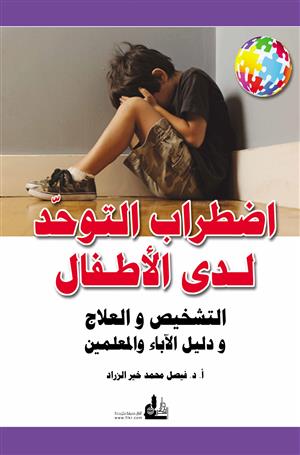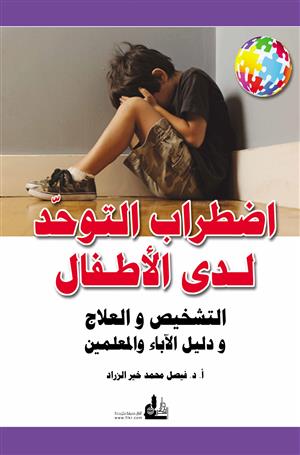اتجاه الأسرة نحو الطفل الذي يعاني اضطرابَ التوحد
( Family attitude toward autistic child )
إن أفراد الأسرة لهم مشاعرهم وأحاسيسهم ومشاغلهم الخاصة والعامة، ويتأثرون بكل ما يدور حولهم، كما أن لهم قدرات محدودة على الفهم والأداء والتعلم والصبر أو التحمل، وتربطهم علاقات مع الكثيرين من الأفراد، وقد يتعكر صفو هذه العلاقات بسبب الحزن والألم والضغوط النفسية والقلق والانفعالات وغير ذلك، ومن الطبيعي أن هناك فروقاً اجتماعية وثقافية واقتصادية وصحية بين أسرة وأخرى، ولعل أصعب اللحظات التي يتأثر بها الأهل هي لحظة تشخيص حالة طفلهم على أنها حالة اضطراب توحد أو ما شابه ذلك... حيث يشعر الأهل بالحزن والألم والخوف والقلق، كما يشعرون بالذنب والخجل، ومن الصعب على الطبيب أو أي اختصاصي معرفة ما يدور في ذهن الوالدين (والأسرة بشكل عام)، وما يحدّثان به نفسيهما حول مشكلة طفلهم من أفكار وتصورات قاسية ومؤلمة ومحزنة، لذلك ينصح الطبيب والاختصاصي أن تؤخذ بعين الاعتبار مشاعر الوالدين وأسرة الطفل عند تشخيص حالة طفلهم، وللأسف ليس كل طبيب أطفال، أو كل طبيب نفسي أو اختصاصي يدرك أهمية هذه النقطة، وقد يقصّر هؤلاء في شرح طبيعة الاضطراب للوالدين وفعالية الدواء والعلاج، وذلك لكي لا يزيدوا من قلقهما ومخاوفهما مما قد يزيد من حماية الطفل، أو نبذه أو يؤثر سلباً في حالة الطفل، (ويمكن أن يكون ذلك في إطار الإرشاد الأسري لأسرة الطفل)، ومن الضروري أن يكون جميع أفراد الأسرة على معرفة تامة بمشكلة طفلهم حتى يساهموا بدورهم نحوه ويساعدوا في عملية العلاج التكاملي لحالة الطفل.
وقد لوحظ من الدراسات أن معظم ردود فعل الوالدين (والأسرة) تجاه حالة طفلهم، وتجاه ما يصاحب هذه الحالة من اضطرابات سلوكية وأكاديمية واجتماعية وصحية، هي في بادئ الأمر النكران وعدم التصديق بوجود مشكلة في الأسرة، وتقديم مبررات واهية مختلفة حول مشكلة طفلهم، كل ذلك بسبب الوصمة الاجتماعية للأسرة التي لديها طفل يعاني الاضطراب. إن رأي الطبيب غير صحيح، والاختصاصي لم يهتم بتشخيص الحالة، وهناك تناقض بين ما سمعناه وما قاله الطبيب،... إلخ... وعملية إنكار الواقع وتقديم مبررات غير صحيحة هي عبارة عن آلية دفاعية نفسية كثيراً ما يلجأ إليها الوالدان، ومن أجل تجنب الألم النفسي، أو مشاعر القلق والحزن والصراع لديهما، وهي عملية مفيدة مؤقتاً للوالدين لأنها تخلق نوعاً من التوازن النفسي المؤقت في مواجهة مشكلة طفلهم. إن نكران وجود مشكلة أو واقع خارجي أسري مؤلم ومزعج، أو إدراك الواقع مشوهاً، يناسب الاحتياجات النفسية الداخلية للوالدين، كما يناسب تفكيرهم، وأحياناً يميل بعض أفراد الأسرة إلى استخدام الخيال على شكل انسحاب مؤقت، جزئي من الواقع المؤلم، وقد يعمل أحد الأبوين أو كلاهما على كبت مشاعرهما كبتاً ثانوياً، حيث يتم إبعاد الأفكار والتصورات أو المشاعر المؤلمة حول مشكلة طفلهما ونسيان ذلك مؤقتاً من حيّز الشعور... وهنا قد نجد الأهل ينتقلون من طبيب لآخر على أمل الوقوف على طبيب أو اختصاصي يساعدهم في تغيير هذه الأفكار والمشاعر المؤلمة حول طفلهم، بأفكار ومشاعر أكثر إيجابية (حتى ولو كانت مشاعر وهمية غير صحيحة)، وفي بعض الحالات يعمل الأهل ما بوسعهم للتستّر على مشكلة طفلهم، وإحاطة هذه المشكلة بنوع من الكتمان والسرية، وخاصة إذا كانت المشكلة تتعلق بأنثى، وقد تخفي الأم الحقيقة على زوجها وأسرته خشية التقليل من شأنها، والإكثار من نقدها (وخاصة في المجتمعات العربية)، لأن المجتمع وأسرة الزوج والزوج لديهم صورة مثالية عن الطفل الذي ستلده الأم أو الزوجة، طفل لديه قدرات المنافسة الناجحة، مثل الوالدين على الأقل، إلا أن ولادة طفل يعاني فيما بعد اضطراباً (أو إعاقة) يجعل توقعات الزوج وأسرته والأم سلبية، وهنا يحدث تباعد بين الطفل المتوقع، والطفل الذي ولد في الواقع، وهذا ما يفرض على الوالدين تحدي الواقع، وقد تكون المسؤولية الكبرى تقع على الأم، لأن المجتمع غالباً ما يعتبر الطفل مثل هدية من الأم لزوجها، وفي حالة وجود مرض أو اضطراب أو إعاقة فإن الهدية تصبح غير لائقة، ويفسر ذلك بأنه خطأ أو عيب من الزوجة (وهذا يخالف ما جاء في القرآن الكريم الذي يقول: فَجَعَلَ مِنْهُ (أي من الرجل) الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى [القيامة: 75/39]. صدق الله العظيم.
وفي هذه الحالة تدرك الأم خيبة الأمل لدى زوجها على أنها خيبة أمل سببها الأم ذاتها، وقد تنجح الأم بالتستر على مشكلة طفلها، إلا أن الأب غالباً ما يبني آمالاً كبيرة وتوقعات على طفله، ومن الطبيعي أن أسلوب التستر هذا يكون مؤقتاً ولا فائدة منه، وفيما بعد قد يدرك الطفل أن هذا الأسلوب مؤشر إلى عدم تقبل، وهذا ما يزيد من خوف الطفل وقلقه وإحباطه ويشعره بأنه طفل ناقص أو غير مقبول... ويمكن القول: إنه في وقتنا الحاضر، وبفضل التقدم العلمي والتطور الحضاري وزيادة توعية الأسر أصبحت مشاعر الوصمة الاجتماعية، وعمليات التستر على مشكلة الطفل أقل حدة من السابق إلا أن بعض الآباء والأمهات ما زالوا يواجهون صعوبة في تقبل طفلهم صاحب المشكلة.
من ناحية أخرى، قد ينظر بعض الآباء إلى مشكلة طفلهم المعاق أو المضطرب على أنه عقاب إلهي للأبوين بسبب ذنوبهما، ويشعر الأهل بالحزن واليأس والإحباط والألم، ويتساءلون لماذا حدث لهم ذلك؟ وماذا اقترفت أيديهم؟ ولماذا هذا الطفل بالذات؟ وغالباً ما تكون هناك تفسيرات تعزز هذا الإحساس باليأس، فإذا عرف الأهل السبب الحقيقي وطبيعة مشكلة طفلهم، وأن هذا الأمر شائع... لم تعد هناك مشكلة، أو أن المشكلة تصبح أقل حدة، إنما المشكلة تزداد عندما يشعر أحد الوالدين (وخاصة الأم) أنه السبب في ذلك، وهذا ما ينمّي مشاعر الإثم والذنب والغضب والإحساس بالدونية والندم... وقد يوجّه أحد الأبوين مشاعر الإثم والغضب نحو نفسه لاعتقاده بأنه قام بظلم طفله، وقد يسقط لومه على الآخرين لأن مشاعر الإثم والألم لديه لم تعد تُحتمل مع الإحساس بالندم على إنجاب الطفل (وهذا قد يكون له مضاعفات نفسية على حمل آخر في الأسرة)، وقد يعتبر الوالدان أو أحدهما أن ولادة طفل مضطرب هو عقوبة من الله، ويبدأ كل والد بتذكر خبراته العاطفية والجنسية السابقة ومواقف الزنا والإدمان والحوادث السابقة... وهذه تعتبر أساليب دفاعية نفسية للتخفيف من مشاعر الإثم والندم، وأحياناً قد تتحول مشاعر الإثم والندم إلى قسوة على الطفل بسبب سلوكه، مما يزيد الأمر سوءاً (شكل من الإزاحة النفسية Displacement )، وإذا اشتد الإحساس بالإثم والندم والاكتئاب والقلق... فقد يؤدي ذلك إلى ابتعاد الأهل (أو بعضهم) عن الطفل، وقد يُسْقِطُ أحدُ أفراد الأسرة، أو أحد الأبوين، سبب المشكلة على الآخرين، مما قد يخفف الإحساس بالذنب ومشاعر اللوم والندم... مثلاً من هذه الإسقاطات: الطبيب لم يحضر في الوقت المناسب، طبيب الأسرة أخطأ في تفسيره لحالة الطفل، عندما ارتفعت درجة حرارة الطفل لم يتم إسعافه في الوقت المناسب... إلخ، وقد يُسقط الأهل اللوم على المدرسة، أو على الاختصاصيين، وتفسيرات كهذه أمام الطفل قد تجعل الطفل يقلل من احترام هؤلاء الأفراد ومن شأنهم، وهم أهم الأفراد الذين يمكنهم علاجه ومساعدته، وقد يتكون لدى الأبوين (أو أحدهما) ردود فعل معاكسة، حيث يتم التعبير عن المشاعر المؤلمة بما يناقضها، فالأم النابذة أو الرافضة لطفلها، والتي لا تستطيع تحمل ذلك؛ نجدها تفرط في رعاية طفلها وحمايته وتدليله... وهذا مفيد عندما يكون الطفل في حاجة إلى ذلك، ولكن ذلك خطر وضار إذا أفرطت الأم (أو أحد الأبوين) في ذلك، حيث على الأهل تعويد طفلهم الثقة بالنفس والاعتماد على النفس تدريجياً. ومن المؤسف أن الحماية المفرطة للطفل تعمل على إخفاء مواضع الضعف لديه، إن الطفل يعي ما يدور حوله، وفي حالة الحماية الزائدة له قد يتساءل: لماذا يكلف أفراد الأسرة ببعض المهام ويستثنى هو من ذلك؟ صحيح أن هذا الطفل يعاني اضطراب التوحد، ولكنه طفل حساس يشعر ويفهم ما يدور حوله. ثم إن عملية الحماية الزائدة (أو النبذ) تجعل الطفل يحرم من كثير من الخبرات التي من المفروض أن تقدم له لمساعدته على تخطي مشكلته وعلاجه.
وتتكرر عملية نقل الطفل من عيادة لأخرى ومن طبيب لآخر على أمل الوصول إلى حل أو إلى علاج فعال لمشكلة الطفل، أو على أمل الوصول إلى طبيب يؤيد أفكار الوالدين (مثلاً أفكار النكران) حول مشكلة طفلهم. وهنا قد نجدهم يمدحون ويطرون الطبيب الجديد، ولكن سرعان ما يتعرض هذا الطبيب الجديد إلى المقت والذم والهجوم عندما يكتشف الأهل أن حالة طفلهم بعد العلاج لم تتحسّن، حيث ينتقل الأهل إلى طبيب جديد آخر، وهكذا يضيع الوقت ويحرم الطفل من استغلال هذا الوقت في التزامه ببرنامج علاجي مفيد وفعال، لهذا فإن توافر الثقة بين الطبيب والطفل وأهله هام جداً في عملية العلاج، وعندما يتطرف الأهل في رعايتهم لطفلهم في نوع من رد الفعل تجاه إحساسهم بالذنب، فهذا يزيد من صراعاتهم، ونجدهم أمام الناس يقدمون كل عناية لطفلهم ويحاولون الضغط على مشاعرهم، وعندما يفكرون وحدهم نجدهم يظهرون كل الآلام والغيظ والإحباطات والمخاوف... ويكررون ذكر ما يعانونه من عذاب وآلام في سبيل طفلهم، ومع نمو الطفل نجده يدرك، ويسمع، ويلاحظ أن هذا التصرف من قبل والديه لا يقابله اعتراف منه أو تقدير فهو طفل لا ينفع لشيء ولا قيمة له، ولا يستحق ذلك، وبعض الأسر قد تنسحب من أنشطتها الاجتماعية للاهتمام بطفلها، وبعضهم يبالغ في ذلك، مما يؤدي إلى توتر الأسرة وتفكك وظائفها، وإذا كان أحد الوالدين يشعر بالنقص والدونية لسبب ما، نجده يعوض عن هذا النقص ويشعر بالقيمة وبأنه مصدر حاجة للآخرين، وأن هناك طفلاً في الأسرة يعتمد عليه، وهنا يزداد إحساس الطفل بقصوره، وبوضعه، وبزيادة اتكاله وسلبيته... ومع نمو الطفل أيضاً والتحاقه بالمدرسة فإن الحقيقة (أي حقيقة مشكلة الطفل) تتضح أكثر فأكثر (ولم تعد آلية الإنكار مفيدة) حيث يكتشف المعلمون مشكلة الطفل، أو يتم إبعاده عن المدرسة، وهذا ما يزيد من شدة الضغوط على الأسرة، وكثير من الآباء يسايرون هذا الضغط ويتكيفون معه، بعد فترة من المعاناة، يضاف إلى ذلك ردود فعل الإخوة والأخوات والأطفال الآخرين حيث ينتاب الإخوة الإحباط والغضب بسبب ما يتحملونه من أخيهم، فإذا صرخ أو بكى أو اعتدى... الأخ صاحب المشكلة عوقب الإخوة من أجله، وإذا اختلف الوالدان حول أسلوب تنشئة الطفل ودور كل منهما، فإن ذلك يؤدي إلى نزاع وجفوة بين الطفل وباقي أطفال العائلة، وتكون الحالة أسوأ لدى الوالدين المطلقين، حيث ينتقل الطفل من عائلة الأب إلى عائلة الأم وهكذا، وبعض الإخوة قد يحاولون تحويل نزعاتهم المكبوتة عن طريق إزعاج الطفل المصاب الذي قد يثيرونه للقيام بتصرفاته السخيفة المضحكة، وهنا قد يعاقب الأهل الطفل المصاب، وأحياناً يحاول الأهل مقارنة بعض أطفالهم ببعض ويحاولون إخفاء التفوق والنجاح للإخوة من أجل ألاَّ يشعروا الطفل المريض بأنه أقل منهم، وهذا عوضاً عن تشجيعهم وتقديم المكافآت لهم.
وباختصار، تعيش الأسرة في حالة حيرة وقلق وخوف (مما قد يتطلب الإرشاد الأسري المبكر للأسرة)، كما تعيش أساليب نفسية دفاعية، وحالة إرباك وإحساس بالذنب وبالإحباط والاكتئاب، ولوم كل فرد للآخر، وإنكار، وحماية زائدة للطفل، وتسامح مفرط، أو تشدد وجمود، أو تقبل للطفل، أو رفضه ونبذه، مع البحث عن علاج أسطوري، والعمل على إعادة تنظيم الموقف الأسري الحياتي ككل، ويحدث أن تتصادم الأدوار داخل الأسرة، وينتهي الصراع بإرغام الطفل صاحب المشكلة على السير نحو هدف دون آخر، وقد يرفض الطفل ذلك، ويصارع من أجل قيامه بأدوار فرضت عليه ولا يستطيع تحقيقها، أو بعيدة المنال عنه، ومن المؤسف أن المجتمع يدرك الطفل وكأنه يحمل عدداً من أشكال القصور في وقت واحد ليس فقط أعراض التوحد أو فرط الحركة، بل التأخر العقلي، والتأخر الدراسي، والجنوح، والإعاقة... إلخ، علماً بأن الطفل لا يعاني إلا مشكلة واحدة وهي مشكلة التوحد.
أما عن الطفل صاحب المشكلة فإنه يشعر بالنقص، وبالقسوة، وبأنه أصبح عبئاً على غيره، نجده يعاني الإحباط، والخوف والقلق، وضعف الثقة بالنفس، وبالتردد، وفي المواقف الجديدة تأخذ الطفل الحيرة، والتذبذب بالسلوك، يجرّب الأشياء بشكل حذر. الطفل لا يعاني مشكلة في حد ذاتها بقدر ما يعانيه بسبب مواقف الحياة المتغيرة من حوله، ومن المواقف النفسية الجديدة التي يتعرض لها، الطفل يعيش مع أفراد عاديين، وهو يعيش مع عالم نفسي وعقلي تفرضه عليه مشكلته، وهناك تداخل بين عالم الكبار العاديين وعالم الطفل صاحب المشكلة، وعلى الطفل أن يحاول ويتعلم كيف يتكيف مع عالم العاديين، ولكنه في الواقع لا يستطيع، لذلك عليه الالتزام بالتوجيه والتدريب والتعليم لتحقيق ذلك، وطفل التوحد قلما يلتزم بذلك، مما يجعله يواجه القسوة والضرب أحياناً بسبب يأس الوالدين ونفاد صبرهم ومحاولاتهم. هذا إلا أن وعي الكثير من الآباء يجعلهم يدركون حقيقة مشكلة طفلهم ويعملون على علاجها، أو التخفيف من حدتها عن طريق اللجوء إلى الاختصاصيين والأطباء، ويتقبلون هذه المشكلة، ويساهمون بدور فعال في مواجهتها ودون أي انفعالات أو تفكير كارثي أو لوم للذات أو للآخرين.
تأتي قيمة هذا المرجع العلمي من طبيعة الموضوع الذي يتناوله والشمولية التي يتسم بها، مع الحرص على تقديم أحدث الدراسات العلمية والنتائج التي انتهت إليها في إطار التوحد،وهذا ما يجعل أهمية هذا الكتاب تتعدى الجانب الأكاديمي العلمي، ليصبح أمراً مهماً ومفيداً؛ لكل أسرة، ولكل معلم، وطبيب، وللمجتمع بشكل عام، وعلى المستوى التشخيصي والعلاجي والوقائي.
نأمل أن يشكل هذا الكتاب جزءاً من الجهود الوقائية لحماية أطفالنا من التعرض لمثل هذه الاضطرابات، ولتخفيف معاناة الأمهات والآباء وجميع المعنيين.
يعدّ هذا الكتاب دليلاً للأمهات، والآباء، والمعلمين، وطلبة الجامعات، وأطباء الأطفال، وأطباء النفس، وغيرهم من اختصاصين ومهنيين.