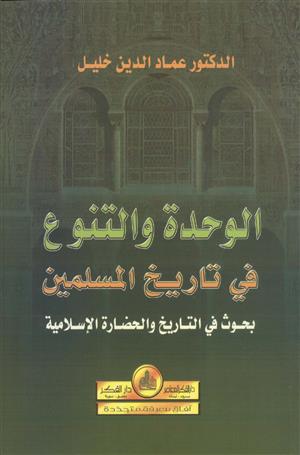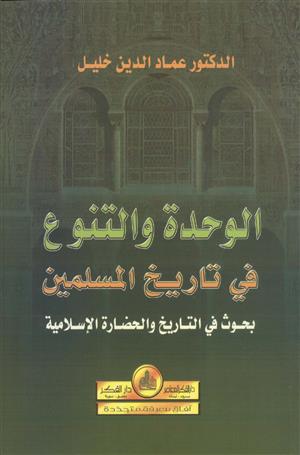الوحدة والتنوّع في تاريخ المسلمين
- 1 -
تنطوي الخبرة التاريخية للإسلام على واحدة من أكثر الصيغ مرونة في التاريخ البشري بصدد قانون الوحدة والتنوع، أو ظاهرة التعددية في سياقاتها المختلفة.
إن الجدل، أو الحوار بين التصور الإسلامي والتاريخ أمر مؤكد، ليس بصيغة مثلثين تناظرت زواياهما، ولكن بصيغة أخذ وعطاء جعلت الخبرة التاريخية تعكس، بشكل أو بآخر، ثوابت ومفردات التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان وقوانين الحركة التاريخية.
ما الذي أرادت التأسيسات القرآنية أن تقوله في هذا المجال، فانعكس بالتالي في نسيج الفعل التاريخي؟
إن الوحدة والتعددية أو التنوع قائمان في صميم العلاقات البشرية، إنهما وجهان لعملة واحدة إذا صحّ التعبير، والوحدة في وجوهها كافة لا تنفي التنوع، كما أنه بدوره لا ينفي الوحدة. إنهما يتداخلان ويتوازيان، ويؤثر أحدهما في الآخر، بل قد يرفده بعناصر القوة والخصب والنماء. قد تحدث حالات تقاطع تقود أحياناً إلى النفي والتعارض، لكن الخط الأكثر عمقاً وامتداداً هو أن التجربة البشرية منذ لحظات تشكلها الأولى وحتى يقوم الحساب إنما هي تجربة تتعدد فيها الانتماءات وتتغير العلاقات وتتنوع القناعات. وإن هذا التغاير في حدوده المعقولة، ومن خلال تعامله مع الثوابت التوحيدية، هو الذي يمنح التاريخ البشري ليس فقط تفرده وخصوصيته وإنما قدرته على الفعل والصيرورة.
في المنظور القرآني يبدو التنوع مستقطباً عبر مجراه الطويل بكلمتي الإيمان والكفر، أو الحق والباطل، ترفده جداول وأنهار متشابكة تجيء من هذا الصوب أو ذاك، ومن خلال هذا التغاير تتحرك مياه التاريخ فلا تركد ولا تأسن وتحفظ بهذا قدرتها على التدفق والنقاء.
إن الإرادة الحرة والاختيار المفتوح اللذين منحا للإنسان فرداً وجماعة، الانتماء إلى هذا المذهب أو ذاك، يقودان بالضرورة إلى عدم توحد البشرية وتحولها إلى معسكر واحد أو أرقام في جداول رياضية صماء. إن قيمة الحياة الدنيا وصيرورتها المبدعة تكمن في هذا التغاير، وإن حكمة الله سبحانه شاءت -حتى بالنسبة للكتلة أو المعسكر الواحد- أن تشهد انقساماً وتغيّراً وتنوعاً وصراعاً.
والقرآن الكريم يحدثنا عن هذا التغاير في أكثر من صورة، ووفق أشد الصيغ واقعية ووضوحاً: {لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ} [المائدة: 5/48] {وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ ، إِلاّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} [هود: 11/118-119]، {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ ما اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ ما اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ}[البقرة: 2/253] .
بل إن القرآن انطلاقاً من منظوره الواقعي لحركة التاريخ البشري يبين في أكثر من موضع أن (الأكثريات) البشرية تقف دائماً بمواجهة الحق الذي لا تنتمي إليه إلا القلة الطليعية الرائدة، نظراً لما يتطلبه هذا الانتماء من جهد وتضحية وعطاء لا يحتملها الكثيرون: {بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ} [المؤمنون: 23/70].
وكثيراً ما يكون اختلاف الألسنة والألوان الذي يعقبه تغاير الثقافات وتعدد الأعراق، أحدَ العوامل الأساسية التي تكمن وراء التنوع التاريخي الذي هو بحد ذاته صيغة من صيغ الإبداع الإلهي في العالم: {وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ، وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ، وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِلْعالِمِينَ} [الروم: 30/20-22].
أما عن الهدف من وراء هذا التغاير، فإن القرآن يجيب: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ} [البقرة: 2/251]، {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيها اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمُورِ} [الحج: 22/40-41].
تلك هي الأمور الأساسية، إن هذا التغاير والتدافع المركوز في جبلة بني آدم يقود إلى (تحريك) الحياة نحو الأحسن، وتخطي مواقع الركود والسكون والفساد ومنح القدرة للقوى الإنسانية الراشدة كي تشد عزائمها قبالة التحديات، وأن تسعى لتحقيق المجتمع المؤمن الذي ينفذ أمر الله، وكلمته في العالم.
وثمة آيات أخرى تبين لنا كيف أن هذا التغاير الذي يعقب تدافعاً وصراعاً إنما هو ميدان حيوي للكشف عن مواقف الجماعة البشرية والتعرف على أصالة المؤمنين. ففي جحيم القتال وعلى وهجه المضيء يتضح الذهب من التراب، ويتميز الطيب من الخبيث وتتحول (التجربة) إلى منخال كبير يُسقط، وهو يتحرك يميناً وشمالاً، كل الضعفة والمنافقين والعاجزين والمترددين في مواصلة الحركة صوب المصير المرسوم {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبارَكُمْ} [محمد: 47/31].
{لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ} [الأنفال: 8/37].
وما أكثر ما يتساءل الإنسان عن الحكمة من التقاتل والقصد من سفك الدم البشري، وما أكثر ما تخيل الفلاسفة والمفكرون عالماً لا يشهد قتالاً ولا تسفك في ساحاته الدماء، ولكن هيهات ما دامت المسألة مرتبطة في جذورها بالوجود البشري المتغاير، المتنوع. وما يزال الصراع أمراً لا مفر منه إذا ما أريد للحياة الإنسانية أن تتحرك وتتقدم وتتجاوز مواقع السكون والفساد: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 2/216]. إلا أن القرآن - وهو يتحدث عن الصراع الناجم عن التغاير البشري في المذاهب والأجناس واللغات والمصالح والبيئات الجغرافية - لا يقصر المسألة على التقاتل والتدافع، إنما يمدها إلى ساحة أوسع، ويعطي للتغاير البشري آفاقاً بعيدة المدى، تبدأ بإشهار السلاح وتمتد لكي تصل إلى الموقف الأكثر إيجابية الذي يجعل هذا التغاير سبباً لعلاقات إنسانية متبادلة بين الأمم والأقوام والشعوب تسعى للتقارب والتعاون والتعارف، مع بقاء كل منها على مذهبه أو جنسه أو لونه أو لغته أو بيئته الجغرافية: {يا أَيُّها النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 49/13].
- 2 -
وعندما تطرح قضية التعددية في واقعنا الحديث، على بساط البحث، فإنها ستثير العديد من الأسئلة قد يأخذ بعضها طابع التحدي الذي يتطلب استجابة ما وينتظر جواباً مقنعاً، وقد يبرز من بين هذه سؤالان أساسيان، يمضي أحدهما صوب المستقبل لكي يتابع طبيعة المتغيرات التي يمكن أن تتمخض عن أية محاولة جادة تدخل في حوار فعال مع ظاهرة التنوع أو التعددية في الحياة العربية الإسلامية، ويمضي ثانيهما عائداً باتجاه الماضي موغلاً فيه حتى الجذور، لكي يتفحص حجم المحاولة على مستوى التاريخ، ولكي يضع يديه على مصداقيتها المتحققة في الزمان والمكان، ويؤشر بالتالي على فاعلية وخصوصيات التعامل الإسلامي مع الظاهرة على مستويي النوع والعدد.
وبالتأكيد فإن القضية لا تتخلق في الفراغ، كما أنها إذا استندت فحسب على أصولها العقدية التصورية بعيداً عن تماسها مع الواقع، وقدرتها على إعادة تشكيله، فإنها قد لا تمنح - بالنسبة لفئة من الناس - القناعات المتوخاة.
بعبارة أخرى إننا إذا قدرنا على وضع أيدينا على مجموع الوقائع التي شهدها التاريخ في هذا السياق، بعد إضافة المؤثرات الإسلامية على الظاهرة ، إذا قدرنا على تحديد النتائج المتميزة التي تمخضت عن هذا التقابل بين العقيدة والتاريخ، فإننا سنعطي القضية المزيد من المسوغات وسنمنحها عمقاً تاريخياً واقعياً يعد واحدة من الفرص الأساسية في اختبار الأفكار والعقائد والتصورات، وفي امتحان المحاولات التي تسعى إلى تشكيل المستقبل المنظور على هديها.
إن البعد التاريخي لأية دعوة سيظل مطلباً لاختبار مصداقيتها جنباً إلى جنب مع البعد التصوري، ومدى ما يملكه من شمولية وتماسك وقدرة على الاستمرار، بموازاة المطالب الإنسانية وتحديات التاريخ.
ولطالما دَرسنا التاريخ الإسلامي أو دُرِّسناه وفق منطلقات خاطئة متعمدة حيناً، وغير متعمدة أحياناً، ولكن النتيجة كانت في معظم الأحيان تعميق الخندق بين طرفي القضية، وكأن ليس هناك تأثير ذو فاعلية عالية، يلتقي فيه التصور مع الواقع لكي يعيد بناءه أو تشكيله، أو لكي يجري في تركيبه - على الأقل- تغييراً من نوع ما يعبر في نهاية الأمر ليس فقط عن رغبة هذا الدين في إعادة صياغة العالم وفق منظوره ومقولاته، ولكن -أيضاً- عن قدرته على تحقيق هذا الهدف العزيز.
- 3 -
ومنذ بداية تشكله الأولي وحتى العصر الحديث، تضمن مجرى التاريخ الإسلامي خبرات وحدوية غنية متواصلة تجعل المرء يميل إلى الاعتقاد بأن التوجه الوحدوي للأمة الإسلامية، على مستويي القواعد والقيادات ليس مجرد خصيصة من خصائصها بل هو محرك أساسي لمساحات واسعة من تحققها التاريخي.
لكن هذا ليس سوى أحد وجهي الظاهرة أو الحالة التاريخية، وإن كان هو الوجه الأكثر ثقلاً وامتداداً، فهناك بموازاته، بل في نسيجه، تعددية من نوع ما.. تنوع هنا وهناك، في السياسة، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي الفكر والمذهب، بل حتى في الدين ((لنتذكر مثلاً أحادية الماركسية ومصادرتها للفكر الآخر وعقيدته ودينه. لنتذكر أيضاً محاولة الكاثوليكية الأسبانية المسيّسة على يد فرديناند وإيزابيلا ورجال الدين، تلك التي ألغت أمة كاملة من الحساب، لنتذكر هذا قبالة تنوع النسيج الديني في معظم مساحات التاريخ الإسلامي، حيث أتيح للنصراني واليهودي والمجوسي والصابئي والبوذي والهندوسي... إلى آخره ، أن يعبّر عن نفسه وأن يقول كل ما يريد أن يقوله، وأن يمتلك مقومات الديمومة والبقاء والامتداد في بيئة إسلامية لم تمارس في الأعم الأغلب أية مصادرة أو قسر أو نفي لعقائد الآخرين)).
.......
.......
إن الإرادة الحرة والاختيار المفتوح اللذين منحا للإنسان فرداً وجماعة للانتماء إلى هذا المذهب أو ذاك يقودان بالضرورة إلى عدم توحد البشرية وتحولها إلى معسكر واحد أو أرقام في جداول رياضية صماء.
إن قيمة الحياة الدنيا وصيرورتها المبدعة تكمن في هذا التغاير وإن حكمة الله تعالى شاءت -حتى في الكتلة أو المعسكر الواحد- أن تشهد الدنيا انقساماً وتغيراً وتنوعاً وصراعاً.
وعندما تطرح قضية التعددية في الواقع الحديث على بساط البحث فإنها ستثير عدداً من الأسئلة يأخذ بعضها طابع التحدي الذي يتطلب استجابة ما وينتظر جواباً مقنعاً..
فكيف يكون ذلك.. ربما يجيب الكتاب عن هذه المسألة ويصفها.
الوحدة والتنوع في تاريخ المسلمين - بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية
د. عماد الدين خليل
يتناول هذا الكتاب بحوثاً في التاريخ والحضارة الإسلامية عن الوحدة والتعدد، أو التنوع في تاريخ المسلمين، اللذين يؤثر كل منهما في الآخر ولا ينفيه، ويرفده بين المسلمين أنفسهم ومع الآخرين بعناصر النماء.
ويدرس في الأصول الإسلامية المحفّزة للفعل الحضاري، العلوم التطبيقية ومعطياتها، وعوامل ازدهارها وتوقفها في تاريخ المسلمين.
ويبين مفهوم تكامل الجهد في (حطّين) عبر المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي، وأبعاد التخريب المغولي في بغداد، والرؤية التربوية الإسلامية في مقدمة ابن خلدون بموازنتها بمقدمة حاجي خليفة في كتابه (كشف الظنون).
ويدرس بتحليل عميق عدداً من الكتب: حركة التاريخ بين النسبي والمطلق في رسائل النورسي، المسلمون وكتابة التاريخ، التحدي الصليبي للوجود الإسلامي في إسبانية، عدة الحرب في نهج الرسول القائد وممارساته، نظرات في الحضارة الإسلامية، دراسات في تاريخ صدر الإسلام (الرسالة والخلافة الراشدة)، شخصيات من التاريخ بداية عظيمة لنهاية أليمة، الطريق إلى القدس، بيعة العقبة الأخيرة، اليهود في الدولة العربية الإسلامية في الأندلس، سورة الإسراء وبنو إسرائيل، الفقهاء والسلطة وصناعة الحياة، قراءة جديدة في دار الأرقم وهجرة الرسول إلى المدينة.
ويبين خصائص كتاب (هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس)، ويدعو إلى المنهج التاريخي في الكتابة الإسلامية المعاصرة، ويدحض مفتريات صدرت بمقالتي (نحو تاريخ جديد) و (قس ونبي، بحث في نشأة الإسلام).