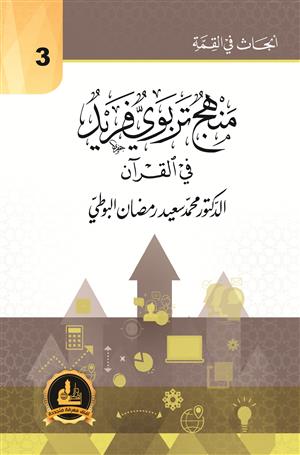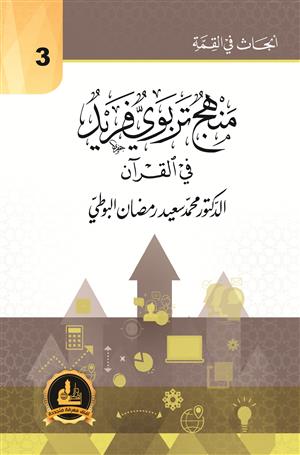إنَّ مناهجنا التربوية التي يؤخذ بها أطفال المدارس عندنا، لا تزال مِزْقاً من نظريات أجنبية نُقلت إلينا كما هي بعد أن صِيْغت بلسان عربي مبين أو غير مبين، دون أن يراعى أثناء نقلها الاختلافُ الكبير بين طبيعة النفوس الأجنبية التي صيغت هذه النظريات على قدرها وطبق مزاجها، وطبيعةِ النفوس المسلمة التي أُشربت فطرةَ الإسلام ونشأت في كنفه ورعايته، مهما بلغ تأثيره في المجتمع قوة وضعفاً!
ومعلوم أن المناهج التربوية كما تؤثر في طريقة التعلم والسلوك، فإنها تتأثر هي الأخرى – عند نشأتها – بما هو راسخ في المجتمع من سلوك وفلسفة وطريقة في العلم والفهم.
فلا ريب أن هذه المناهج لا تتناسق إلَّا مع المجتمع الذي نشأت فيه وتفاعلت معه، ومن الغباء أن نتصور اتّساقها مع العقلية أو النفسية التي نشأت تحت إشرافها، مقياساً صحيحاً لاتِّساقها مع أي عقلية أو نفسية أخرى غير التي ولدت في ظلها، واستمدت منها ضوابطها ومعالمها المنطقية والفكرية.
فالدين - مثلاً – في المجتمع الأوروبي، لا ينهض في أُسسه وتعاليمه على أكثر من حوافز عاطفية ووجدانية، ولذلك كانت مناهج التربية الدينية فيه قائمة على إثارات وجدانية مجردة، كثيراً ما تكون مجنَّحة، أو بعيدة، عن سلطان الفكر والعقل.
ولذلك كان الدين نفسه عند الأوروبيين ظاهرة اجتماعية.
والدين عندنا – وهو الإسلام – إنما ينهض في جملة عقائده ومبادئه في أُسس ومقتضيات عقلية ثابتة، يُستنهض لفهمها المنطقُ والفكر.
فلو استعرت للتربية الدينية عندنا تلك المناهج العاطفية والاجتماعية المجردة، لباءت بفشل ذريع، ولما أورثت أي نتيجة تربوية سليمة. ومعلوم أن البنية العامة، لمناهج التربية الدينية عندنا، مأخوذ من تلك الأسس والطرق التربوية المتبعة في الغرب.
والعقيدة – فيما تقضي به أحداث النظريات الفلسفية والتربوية في الغرب – يجب أن تنشأ في ظل الإرادة وتَبْعاً للرغبة.
فالرغبة في شيء ما (ولا تكون هذه الرغبةإلَّا تبعاً لغرض) هي التي توجد في العقل حوافز الاعتقاد بالكون أو الوجود حسب مقتضيات تلك الرغبة.
وعلى المناهج التربوية هناك أن تُيَسَّر إلى العقل في سبيل هذه الحوافز .
والعقيدة عندنا، وفيما تمليه علينا حقائق الإسلام نفسه، يجب أن تكون الأساس المطلق للإرادة والرغبات الإنسانية على اختلافها، فلا تسير الإرادة ولا تتجه الرغبة إلَّا تبعاً لما تخطّه العقيدة الحرَّة المطلقة.
ولذلك كان عليها أن تنطلق في وجودها من نقطة الصفر أو اللاشيء – كما يقرر الغزالي – ليس معها إلَّا عدَّة من العقل والمنطق المجردين، شريطة أن تتوفر فيهما مقوِّمات السلامة والكمال.
وعلى المناهج التربوية عندنا أن تُيسر إلى العقيدة سبيل هذا التحرر المطلق والانعتاق الكلي.
ولكننا على الرغم من هذا، إنما نستعير، لتربية هذه العقيدة السليمة في صدور أطفالنا، تلك المناهج التربوية التي تتعارض معها بشكل حادّ، والتي أُقيمت على أساس يناقضها مناقضة كلية غير قابلة لأيّ جمع أو توفيق.
والغريب أن أحداً من الذين يهتمون بشؤون التربية عندنا، لم يلتفت ذات يوم بأيِّ بحث جدي إلى خطورة هذا الاضطراب المُشين!.ويا ليته كان اضطراباً فقط!..إنه مظهر للفقر المدقع الشديد الذي يفرض على صاحبه أن يستجدي السروال ليجعله غطاءً لرأسه، ويلتقط ربطة العنق ليصوغ منها جورباً لقدمية.
إنَّه مظهر لذل من نوع عجيب، يثير في النفس مزيجاً من الاحتقار والإشفاق.
يتحدث هذا الكتاب، وهو الثالث ضمن سلسلة "أبحاث في القمة"، عن المنهج التربوي الذي تمتاز به صياغة القرآن الكريم خاصّة، ل الذي يتّسم به الإسلام عموماً؛ إذ الإسلام ــ من حيث هو دين ــ يعتبر في مجموعه منهاجاً تربوياً للذات الإنسانية، المتمثّلة في كلّ من النفس والجسد والعقل، لتصعديها إلى مستواها الفطري الأصيل.
كيف يخاطب القرآن في الإِنسان تركيبه العقلي والوجداني المتكامل ويجذبه إلى الحقائق التي يتحدَّث عنها من ملكاته الفكرية والعاطفية كلها بنسب عادلة متساوية؟
وكيف يصيغ خطابه لشتى الطبقات من الناس على اختلاف ثقافاتهم وعصورهم، بحيث يفهم الجميع من المعنى المقصود ما تتسع له ثقافتهم، دون تناقص في الفهم؟
وكيف يسير في محاكماته العقلية على نحو يحكم فيه قواعد المنطق دون اعتماد على ألفاظه واصطلاحاته؟ وكيف يشبع بحديثه كلاًّ مِن الخيال والعقل، دون أن يطغى واحد منهما على الآخر؟
تقرأ الجواب على هذه وغيره، في هذا الكتاب الذي ينطوي على دراسات جديدة كل الجدة في القرآن وإن كان العنوان مألوفاً ومعروفاً بين الناس.