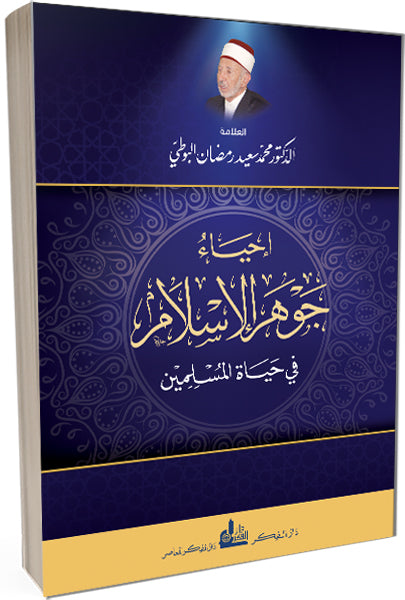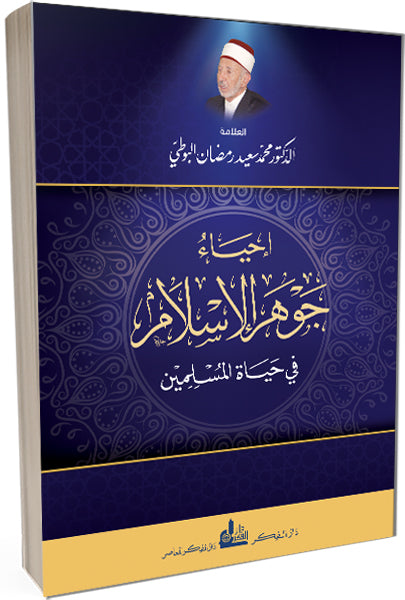هل الدين ظاهرة اجتماعية؟* محمد سعيد رمضان البوطي في حياتنا الفكرية والثقافية نقاط كثيرة تظلّ مضطربة بين دوافع المدّ والجزر، بل تظل مبددة تائهة خلف كلمات وعبارات هي إلى الرمزية أقرب منها إلى الكلام المبين. ولو كانت هذه النقاط هامشية في حياتنا الفكرية، إذن لهان الخطب، ولأجزنا لأنفسنا أن نجعل من موضوعاتها قصائد رمزية يفهمها كل سامع حسب ما يريد، وينال الشاعر بذلك رضا الجميع. ولكنها نقاط تتضمن أهم، بل أخطر قضايانا المصيرية، ومن ثم فهي لا تحتمل إلا البيان الجازم والنصوص المحكمة القاطعة. وفي نظري أن خير ما يُلجئ رجال الفكر والعلم في بلادنا إلى تجلية آرائهم حول هذه القضايا الأساسية، وإلى الابتعاد عن استعمال العبارات ذات الدلالات العمومية أو الغامضة والمتشابهة، وإلى وضع النقاط على الحروف، إنما هو الحوار.. الحوار الوجاهي بين ذوي الأفكار المتعارضة والمذاهب المتخالفة. إذ الأساليب الرمزية والجمل الغامضة والمتشابهة، لا مكان لها بين طرفي حوار، وتلك هي مزية النقاش بين الأطراف، إنها تصقل الفكرة، وتصفيها من الشوائب وأسباب الغموض. وإذا لم يتح لنا أن ننشئ مثل هذا الحوار في ندوات مفتوحة أو مساجلات منظمة، فلا أقل من أن نلاحق أولئك الذين ينثرون أفكارهم فوق المنابر السيارة المتحركة.. أولئك الذين ما يكادون يطرحون آراءهم حتى يولوا سراعاً مدبرين لا يلوون على أحد.. نسعى وراءهم ونسمعهم - جهد الاستطاعة - حوارنا ونقاشنا واستيضاحاتنا، بروح علمية موضوعية هادئة، لعلهم يلتفتون، فيتوقفون، فينصاعون إلى المناقشة والحوار، فتتضح المبهمات وتتلاقى الآراء وتجتمع الكلمة، ولئن لم يتم شيء من ذلك، فحسناً أننا قد أبرأنا الذمة، على طريقة ذلك الفقيه الذي قالوا عنه: إنه كان سائراً في طريق؛ فمرّ به رجل أعجبته القلنسوة التي على رأسه، فخطفها وولى مسرعاً، فتبعه الفقيه ينادي: يا هذا، وهبتك القلنسوة، قل قَبِلت. في حديث أو حوار صحافي قال رئيس قسم الفلسفة بجامعة الكويت: إن من أهم القضايا التي تنتظر الحلّ، مشكلة موقف الإنسان المعاصر من الدين؛ فمفكرو النهضة العربية المعاصرة لم يتخذوا موقفاً صريحاً وجريئاً من هذه القضايا إلى الآن.. ثم قال: إنني وإن كنت لا أدعو إلى ثورة شاملة في هذا الميدان، ولكنني - على الأقل - أدعو إلى فكر مستنير في الميدان الديني. وضرب المثل في الحلّ على الطريقة الأوربية؛ فقد اتخذ الأوربيون موقفاً صريحاً وحاسماً من هذه القضية، وحلوا المشكلة حلاًّ جذرياً عندما حدّوا من سلطان الدين، وأبعدوه عن التدخل في أمور الدولة وأمور العلم. وأنا أوافقه على أن هذه المعضلة من أهم القضايا العربية التي تنتظر الحل.. ولذا فقد كنت أتمنى أن يجعل منها موضوع محاضرة في البلدة التي دعي أستاذاً زائراً إليها، وأجرى هذا الحديث الصحافي فيها، يدعى إليها لفيف ممن سماهم مفكري النهضة العربية المعاصرة؛ من مختلفي الأفكار والاتجاهات، ثم يجري حوار ونقاش علمي رزين بين الأطراف، حول ما قد يطرحه من قناعات وأفكار في هذه القضية.. وفي تصوري؛ أن ثماراً إيجابية ذات أهمية ستتحقق من وراء ذلك، ولسوف يصقل الحوار القضية المطروحة، ويبرز حجمها وجذورها، ويكشف عن الحل العلمي الأمثل لها. ولكن الرجل اكتفى بتحريك الموضوع واستثارة الأفكار إليه، بعبارات ملفوفة وإشارات لدنه ذات احتمالات متعددة. ونظراً لقناعتي التامة بأن المسألة تعدّ - كما قال حقيقة - من أهم القضايا التي تنتظر الحل، وأن على المفكرين اتخاذ موقف صريح وجريء منها، ورغبة مني في الاستجابة الصادقة لدعوته، أقول بكل موضوعية وتقدير: ها أنا ذا كواحد من هؤلاء المفكرين سأتخذ موقفاً صريحاً وحاسماً من هذه القضية، ولسوف أبتعد، جهد الاستطاعة عن استعمال العبارات الشمولية الغامضة أو المحتملة. إن مما هو معروف بداهة أن الدين المتعامل به في حياة الأوربيين، وفي منظورهم الفكري، ظاهرة اجتماعية أفرزها الفكر الإنساني خلال القرون الغابرة، وإن كانت له جذور ذاتية لا علاقة لها بصنع الإنسان، فيما يراه المؤمنون منهم. فمسيحية الغرب - فيما يعرفه الغربيون جميعاً - هي تلك التي صاغها بولص اليهودي، وقسطنطين الروماني. والأناجيل المتداولة ليست - فيما يعرفون ويعتقدون - تعبيراً عن الوحي؛ الذي كان يتنزل على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام؛ وإنما هي كتابات ومذكرات لأولئك الذين يسمون بالرسل، جمعوا فيها أخبار المسيح وطائفة من أقواله. ومن ثم، فإنهم لا ينظرون إلى التعاليم والمبادئ المسيحية، على أنها أوامر إلهية نزلت على بني إسرائيل، أو على الناس عموماً، بحيث لا يسعهم إلا تطبيقها والالتزام بها، وإنما هي فيما يعتقدونه ويجزمون به، مجموعة أفكار وإلهامات وآراء متلاحقة ومتطورة، لقيت استجابة وقبولاً، ثم حظيت من المجامع الكنسية بالاحترام والتقديس. ومن هنا جاز لهم عموماً، وللباحثين الاجتماعيين منهم خصوصاً، أن ينظروا إلى الدين المتعامل به في حياتهم على أنه ظاهرة اجتماعية من نسج الناس وصنعهم. يقول جون ستوارت ميل في كتابه (الحرية)، جواباً لمن قد يقترح تحديد نوع الضرورات التي ينبغي أن تقيّد بها الحرية، في الآداب المسيحية، ولكي يُزيلَ اللجج والخصام في تحديد الضرورات بين فئات المجتمع، يقول تعليقاً على هذا الاقتراح: إن ما يسميه الناس آداب المسيحية - وإن كان الأصح أن يسمى آداب الكهنوتية- ليس مما أخذ عن السيد المسيح، ولا مما نقل عن الحواريين، بل هي آداب وضعتها الكنيسة الكاثوليكية على سبيل التدريج أثناء القرون الخمسة الأولى". ومن هنا جاز لهم أن يجعلوا لأنفسهم سلطاناً في تطويره واستخدامه لما يرونه من منافعهم واتجاهاتهم، وتوسيع أو تضييق مهامّه وصلاحيته، شأنهم في ذلك كشأن من قبلهم.. فليس غريباً ولا مستهجناً في المجتمع الغربي أن يقترح باحث قانوني، أو عالم من علماء النفس أو الفلسفة، مثلاً؛ تغيير كثير من المبادئ والآداب المسيحية، أو توجيهها وجهة مخالفة؛ إذ إن ذلك شأنهم، بل ربما كان داخلاً في صلاحياتهم الاجتماعية، وإن كان الأخذ بتلك المقترحات قد يحتاج إلى إجراءات محددّة. يقول بنتام - وهو عالم بريطاني في الاجتماع والفلسفة والقانون -: "يجب أن يكون سير الديانة موافقاً لمقتضى المنفعة؛ فالديانة بعدّها مؤثراً تتركب من عقاب وجزاء؛ فعقابها يجب أن يكون موجّهاً ضد الأعمال المضرّة بالهيئة الاجتماعية فقط. وجزاؤها يكون موقوفاً على الأعمال التي تنفعها فقط. هذه هي القاعدة الأولية، والطريقة الوحيدة، في حكم سير الديانة هو النظر إليها من جهة الخبر السياسي في الأمة فقط، وما عدا ذلك لا يلتفت إليه". الخلاصة: أن الدين المتعارف عليه عند الغربيين ليس أكثر من ظاهرة إنسانية. ومن ثم فلا عجب أن يتخذوه أداة تسخير لبلوغ رغباتهم وتحقيق أفكارهم، بل لا غرابة في تطويعه لاتخاذه عوناً لتحقيق الكثير من أهوائهم ونزواتهم. ونلتفت الآن إلى الإسلام؛ وهو الدين الذي يعتنقه الغالبية العظمى من سكان البلاد العربية والإسلامية، ونتساءل - بحكم ما رأيناه من واقع الدين في المجتمعات الغربية - كيف ينبغي أن نتعامل مع الإسلام هنا؟.. أنتعامل معه هو الآخر على أنه ظاهرة إنسانية واجتماعية؛ فنستخدمه نحن أيضاً أداة لتحقيق اتجاهاتنا السياسية والاجتماعية وقناعاتنا الفكرية، ثم نقدّره ونلتزم به ضمن هذا النطاق؟ إن الإجابة العلمية والمنهجية عن هذا السؤال تقتضي - بدون ريب - أن نبدأ فننظر إلى الإسلام الذي نتعامل معه وندين به: ما هو وما حقيقته؟ ننظر إليه من خلال دراسة علمية حيادية دقيقة. فإن تبين أنه هو الآخر ليس أكثر من ظاهرة اجتماعية، تجمعت من إبداعات الفكر الإنساني وصنعه خلال القرون المتصرّمة، فإني عندئذ لا أدعو إلى الحدّ من سلطانه فحسب، بل لا بدّ أن أذهب، بكل قناعة فكرية وطمأنينة وجدانية، إلى ضرورة التخلص من سائر قيوده وأثقاله، مردداً مع (سارتر) أطروحته التي يقول فيها: "إن من العبث أن نبحث عن قيم نقيد أنفسنا بها في عالم لا وجود فيه للخالق". أجل.. فإن ذلك أحرى من أن نجامل قيماً لا وجود لها، حتى وإن حصرنا وجودها في المعابد، وربطناها بموازين التربية والأخلاق، كما يفعل الغربيون، بحجة أن الدين عندهم وإن كان لا يتفق مع العلم ومقتضياته، إلا أنه في جملته ذريعة إلى الخير والحب وتصعيد الوجدان. وما من ريب في أن اتفاقنا على اتخاذ ضوابط وقيود تحقق ما نراه مصلحة لنا، خير من أن نربط أنفسنا بقيود وضوابط لا يربطنا بها إلا وهم أنها ضوابط دينية منزلة من عند الله. أما إن قضى قرار البحث العلمي الموضوعي المتجرد من أي أسبقيات فكرية ونفسية؛ بأن الإسلام في أصوله الاعتقادية وبنيانه التشريعي، واقع ذاتي، ذو وجود موضوعي خارج ومستقل عن ذهن الإنسان وكيانه، وأنه ليس حصيلة الفكر الإنساني وإبداعه، فلا مناص عندئذ - إن أردنا أن نكون علميين وموضوعيين حقاً - من الخضوع لسلطانه والتقيّد بأحكامه، كما لا مفرّ لنا من الخضوع لأي ناموس أو نظام كوني مشاهد أمامنا، ذي وجود خارجي عن تصوراتنا وأذهاننا، ويغدو السعي في إقناع الغربيين وتقليدهم - والحال هذه - عبثاً سخيفاً ومضحكاً، لا يعبّر إلا عن ذلّ المهانة والتبعية العمياء في نفوسنا. من كتاب ( إحياء جوهر الإسلام في حياة المسلمين ) الصادر حديثا عن دار الفكر بدمشق
تأتي أهمية نشر هذا الكتاب اليوم من أهمية الأفكار والمشكلات المطروحة فيه، ومدى الحاجة إليها في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها الأمة. ففي حياتنا الفكرية والثقافية نقاط كثيرة تظلّ مضطربة بين دوافع المدّ والجزر، بل تظل مبددة تائهة خلف كلمات وعبارات هي إلى الرمزية أقرب منها إلى الكلام المبين. ولو كانت هذه النقاط هامشية في حياتنا الفكرية، إذن لهان الخطب، ولأجزنا لأنفسنا أن نجعل من موضوعاتها قصائد رمزية يفهمها كل سامع حسب ما يريد، وينال الشاعر بذلك رضا الجميع. ولكنها نقاط تتضمن أهم، بل أخطر قضايانا المصيرية، ومن ثم فهي لا تحتمل إلا البيان الجازم والنصوص المحكمة القاطعة.
يضع المؤلف يده في هذا الكتاب على جوانب هامة من جوهر الإسلام وحقائق الدين التي تبدأ بمعرفة الله تعالى وتنتهي بالعبودية والمحبة له. كما تحدث عن أثر العبادة في ترسيخ العقيدة، وأثر المسجد في ترسيخ الأخوة والمساواة. وأوضح كيف يحب العبد مولاه العظيم بالرغم من تقلبه في آلامه ومصائبه التي ابتلاه بها؟ وردّ على من يتهم الإسلام بالعجز عن معالجة ظواهر الانحراف الاجتماعي، وبيّن دور المرشدين والدعاة في حماية المجتمع. وأخيراً ختم بالرد على دعوات الحداثة ليوضح الفرق بين التجديد المطلوب والتبديل المرفوض.
هذا الكتاب يعالج عدداً من القضايا الحساسة في حياة المسلمين. استهلَّه المؤلف بتعريف وافٍ لحقيقة من حقائق دين الإسلام، وبيّن أن حقيقته تبدأ بمعرفة الله وتنتهي بالعبودية لله، وبدونهما لا يتحقق الإسلام، وأنها الطريقة المثلى لقطف أجلّ ثمرة من ثمرات الإيمان بالله: ألا وهي محبة الله عز وجل. ثم يتحدث عن أثر العبادة في ترسيخ العقيدة الإسلامية في القلوب، وأثر المسجد في ترسيخ الأخوة والمساواة. ويتوقف عند مسألة طالما شوّشت عقول كثيرين، مفادها: كيف يتأتّى للعبد أن يوفّق بين محبّة مولاه، سبحانه وتعالى، وبين تقلّبه في المصائب والآلام التي ابتلاه مولاه بها، والتي هي مدعاة تذمر وسخط عادة، وليست مدعاة حب!! ويردّ على من يتهم الإسلام بالقصور، والعجز عن معالجة ظواهر الانحراف في المجتمع، فيبيّن دور المرشدين والدعاة في حماية المجتمع من الانحراف. ثم يختم بالرّد على دعوات الحداثة التي يطالعنا بها بين الحين والآخر– بدعوى أن الإسلام قاصر عن مواكبة التطور والمستجدات المعاصرة - أناس قد وصفهم رسول الله ? بقوله: ((ألا ليذادن رجال عن حوضي- أي ليطردن - كما يذاد البعير الضال، أقول: ألا هلمّ ألا هلمّ، فيقال: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك، فأقول: فسحقاً فسحقاً فسحقاً)). وأوضح الفرق بين التجديد المطلوب والتبديل المرفوض.